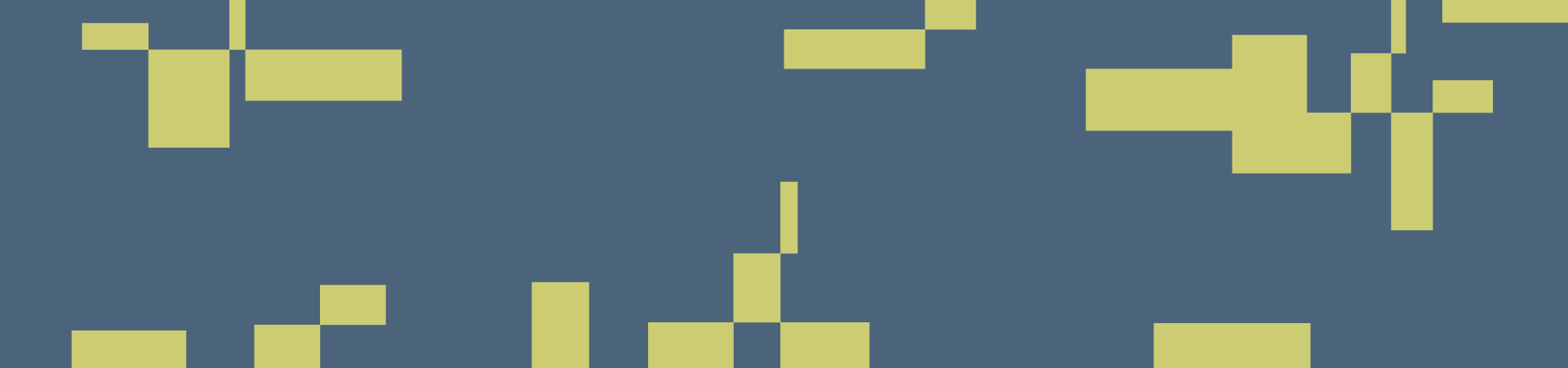Majd Abdel Hamid, Screenshots/running from barrel bomb in cemetery, Dar’s.
Cross-stitch, cotton thread on canvas, 13 x 21 cm (2016)
لسنوات، ظلّت رغبة دفينة تشتعل في داخلي، لم أخبر عنها أحداً. ظلّت سرّاً تردّدت طويلاً قبل أن أتمكّن من صياغته بوضوح: أحبّ الشعور بالألم، الألم المرتبط بالجنس تحديداً. أحبّ أن يصيبني ذلك الوجع الخفيف، كأنه تيار كهربائي لاسع، في مكامن المتعة ذاتها فتتحوّل للذة ونشوة عارمة، أو هكذا كنت أتخيّل وقتها حتى قبل أن أجرؤ على التجربة. لم أكن أعرف كيف أعبّر عن شعوري هذا. ليس الخجل ما يمنعني. فأنا تجاوزتُ الخجل من جسدي ومن كل ما يحيط بالجنس منذ زمن، بل لأن التعريفات دوماً قاصرة وتميل إلى التنميط الذي أمقته.
❂
أجاهد في سبيل منع نفسي من التفكير وأحاول التقوقع حول ما يحسّ به جسدي، علّي أمسك بذلك الشعور قبل أن يطير مثل دخان بخور رديء لا يدوم عطره أكثر من دقيقة وحيدة. ربما كان علي أن أشرب كمية أكبر من الكحول فأجهز على مراكز الإدراك والوعي وأصيبها بشلل مؤقت وأتحرّر من سطوتها. لا الأنوار الخافتة تعينني، ولا الدفء اللذيذ يمكّنني من الاسترخاء بشكل كافٍ. عادة، أنزلق نحو نوم خفيف حينما تستلمني أصابع خبيرة التدليك أو البشرة، وحتى على كرسي الكوافير، يكفي أن يستقرّ جسدي ويهتمّ به أحد ما ليزحف الخدر تدريجياً ويسحبني معه. لكن الليلة حواسي كلها متيقظة بشكل نافر وأخاف أن تُفسد كل شيء.
الوعي لعنة أحياناً. وها هو يتقافز داخل أزقة رأسي ليمنعني من الاستمتاع ويجبرني على التفكير في مدى صواب ما أفعله، بتسليم جسدي لرجل أجهل هويته يعبث به بعنفٍ بارد. أتشبّث بجسدي محاولة التواصل معه مجدداً. أشعر به متحفزاً، مشدوداً كقوس رماية يتأهّب لإطلاق سهم قاتل. يتكرّر السؤال ذاته: هل هذه أنا فعلاً؟ أتفرّج عليّ من الخارج. هل ذلك الجسد المسجّى في استكانة كاملة هو لي؟ أهمس باسمي كعادتي عندما أستغرب وجودي في مكان أو وضع لم أتعوّده. أنادي نفسي باحثةً عن ذاتي التي لا يعرفها غيري. أتذكّر أنني لاحظت وجود مرآة إلى يميني عند دخولي فأطرف بعيني كي أرى نفسي. تمنعني موجة من الألم الخافت المتمركز هناك من التمعن في صورتي. أحدّد الموقع بالتقريب، هناك، حول مكمن الملذات بين فخذيّ. تجتاحني الموجة فأغرق داخلها وأنسى كل شيء، حتى ذاتي.
ها قد بدأت التجربة إذاً. يستعيد وعيي سلطاته سريعاً ليجبرني على التفكير والتحليل. أُعيد تصفيف شعري بأصابعي حتى أرضى عن صورتي المنعكسة وأتمكّن من المضي قدماً دونما إحساس بالانزعاج. كل شيء تحت سيطرتي، كما يجب. يحاول الرجل العابث بجسدي مساعدتي فأرفض، لا أحبّ أن يلمسَ أحدٌ شعري، ويداه تغرقهما سوائل مختلفة معلومة المصدر.
أنطق كلمة السرّ وأوقف كل شيء من أجل فترة راحة قصيرة، أفضّل قضاءها وحيدة، أستعيد زينتي دون أن أنظر في عينيّ. أخاف أن أخرج من الدور الذي أؤدّيه الليلة. الليلة الكبيرة. السؤال ذاته مجدداً: ما الذي أفعله هنا؟ منذ ثلاث ساعات تقريباً كنتُ هناك، في صالة البيت الغارقة في شمس العصاري، ألقي نظرة أخيرة على النسخة الأخرى المطلة عليّ من المرآة. أتمعّن في مظهرها وأعجب بما أراه: ثقتها بنفسها متصاعدة، وهي تدرك جيداً أنها ستجلس عالياً على عرش قائمة النساء المُغوِيات الليلة. أعلم أن عدد النساء في مثل هذه الأماكن دائماً أقلّ من عدد الرجال، مما يجعلهنّ عملةً نادرة. أعلم أيضاً أن وجود امرأة مثلي هناك أندر وأثمن. أتأكّد من وجود كل ما أحتاج إليه في حقيبة يدي متناهية الصغر: قناع ذئب من الدانتيل الأسود، إصبع الروج الأحمر طويل الأمد، وزجاجة عطر صغيرة تحمل اسماً ورائحة مثيرين. أتوسّل لتلك المرأة في المرآة ألا تفكّر كثيراً، وألا يشغل بالها سوى جمالها وتيار الإثارة الذي يتسلّق نصفها السفلي كسرب نمل يعرف وجهته بين فخذيّ.
أقفُ على أعتاب تجربة فريدة قد تبدو مرعبة للكثيرات. لكنني خطّطت وجهّزت كل شيء منذ فترة، وأرسلتُ قائمة الممنوعات والمحظورات للمنظِّمين. فأنا أحرص دائماً على أن تظلّ الأمور تحت سيطرتي. أكرّر في رأسي قائمة الممنوعات، لأشتّت أفكاري التي تنزلق نحو الصوابية: لا قيود تحزّ معصمي أو كاحلي وتؤلمني، لا داعي للألم في غير مواضعه فينقلب انزعاجاً يفسد التجربة كلها. لا أحبّ القيود… أنا هنا بملء إرادتي، لكن ليس للرضوخ لرغبات الآخرين. على العكس تماماً، فلا داعي لمنحهم إحساساً زائفاً بالسيطرة عليّ وعلى جسدي. وحدي أقرّر، ووحدي أحدّد التفاصيل. لا أستمدّ إحساسي بالأمان من أسباب منطقية إطلاقاً، بل أشعر بأن الأمور السيئة لا تحدث إلّا للأخريات سيئات الحظ. لا، لستُ متوترة على الإطلاق. أكذب قليلاً. أكذب تماماً. هل تلك الرعشة التي تكهرب ساقي منبعها الإثارة الشديدة أم القلق الذي يتسرّب لدمي قطرة قطرة؟
الآن وهنا، في غرفة معزولة عن العالم الخارجي بأبواب وستائر مخمل ثقيلة، أرتعش أنا وشموع القداس من الخوف، أو ربما من البرد الذي يلسع جسدي العاري. في حياة أخرى، لأرسلتُ ابتسامة وقبلة للشخص الذي اختار هذا النوع من الشموع تحديداً. لكن الليلة تستحضر ذاكرتي جميع قصص وأفلام الرعب التي قُدّمت فيها النساء قرابين للشيطان. لكنهم يختارون دائما شابات عذارى، صح؟ ولا يدرجون أنجيل وآيا ناكامورا ومايلي التي ترسل لنفسها الورود، ضمن قوائم الأغاني التي يذيعونها، صح؟ أحاول تذكّر الموسيقى التصويرية لفيلم «آيز وايد شات»، فلا يرنّ في جمجمتي سوى قداس موت موتسارت.
حسناً، انصرفي أيتها الروح النكدية، واحضري أيتها الذاكرة المحملة بمئات الساعات من الأفلام الإباحية التي تدور في قصور وأديرة قروسطية، وأسعفيني ببث الإثارة الخالصة في أوصالي. لا أعرف تماماً ماهية الأوصال لكنني قرأتها مراراً، فلأستخدمها أنا أيضاً. إنْ كان لا بد أن ندخل في التجربة، فليكن برجلنا اليمنى وروجنا الأحمر ذي الدرجة المثالية المعروفة باسم إغرااااااء ولنستدعِ روح سونيا سليم وجميع الستات اللعوبات، صاحبات الانحناءات الشهيات، والضحكات المغويات في تاريخنا السينمائي لينقذنني من الخوف. ألجأ إلى حيلة تعلّمتها مؤخراً عندما تغيب الرغبة: أشغّل موسيقى فيلم «الراقصة والسياسي» في رأسي وأتخيّلني أرقص عليها، فيحضرني رجلٌ بعينه.
❂–
أحاول أن أتخلّى عن عبء ادعاء الصلابة والثقة بالآخرين، وأنهم سينصاعون حتماً لرغباتي ويحقّقون أمنياتي. أرتدي جزءاً من ملابسي، وأتجوّل في المكان لأستكشفه على مهل: مبنى من إرث الحقبة الملكية المتأخرة، مرمم بعناية فائقة، ومنذ فترة ليست طويلة حسبما تشي به حالة ورق الجدران الجيدة ورائحة الصمغ التي ما زالت تنبعث منه بشكل طفيف إذا ما قرّبنا أنوفنا منه. تتوالى الصالونات والغرف: بعض منها أبوابه مفتوحة على مصراعيها، وأخرى مزودة بفتحات زجاجية — يبدو أنني أخطأت في التعويذة واستحضرتُ روح المعمارية لا الراقصة. أكادُ أموت عطشاً، فنيران الشمعدانات تبعث دخانا خانقاً، أو ربما هذه هورموناتي التي لا تملّ اشتهاء المخلّص. أبحثُ عن البار، لا بدّ أن يكون هناك واحد هنا. أمرّ وسط الحضور مثل السهم، أرغب في الشرب بسرعة قبل أن أتنحّى جانبا في غرفة ما لألتقط أنفاسي وأفكّر بما أنا فيه.
أشعر أنني حقّقت كل ما حلمت به بمجرد دخول هذا المكان الأسطوري، وعشت تلك التجربة القصيرة اليتيمة. لا أرغبُ في شيء، ثمالة خفيفة فقط وحوض استحمام مترع بماء الخزامى ربما. لن أصل للبار أبداً ولن أعرف مكانه. أقفُ وسط القاعة الفسيحة، غالباً كانت قاعة رقص في حياة سابقة. أقف مجذوبة، لا أقوى على المغادرة. يقفُ هو أيضا هناك، وحده وبكامل ملابسه، بذلة رسمية أنيقة من ثلاث قطع. كنت سأنهار من الضحك لو رأيت رجلاً غيره يرتديها في هذا المكان تحديداً. لكنه يخيفني. أخاف من ردّ فعله وأخاف من نظراته الحادة رغم ابتسامته، أو ربما بسبب ابتسامته تحديداً. لو كنا نصوّر فيلماً لكان هو الشرير الوسيم ذا الكاريزما، الذي يتفوّق على البطل في كل شيء. سيكون حتما الكاهن الأكبر الذي سيشقّ صدري ويخرج قلبي النابض ويلتهمه ليستحضر روح الشيطان، أو لعلّه هو الشيطان ذاته. يجفّف التوتر ما تبقّى من سوائل في جسدي، لكنني لا أتحرّك من مكاني. لا أقوى حتى على أن أرمش بعيني. أنتظرُ فقط إشارة منه وأدرك تماما أنه يريدني. سأخبره بكل ما دار في ذهني لاحقاً، في مكان وزمان بعيدين من الليلة، وسيضحك كثيراً. لكن في تلك الليلة، اكتفى بإشارة خفيفة بيده كي أتبعه مسحورة.
❂
ذكّرني ذلك الرجل الغامض، حينها، بفيكونت فالمون الذي وقعت في غرامه أثناء مراهقتي الجافة، وتمنّيت له النجاح في مساعيه الرامية للإيقاع بأكبر عدد من النساء المتدينات العفيفات والفتيات الغريرات البريئات، ليفتح عالم الملذات المحرمة أمامهن. أُغرمت بجميع شخصيات الأشرار والمنحلّين جنسياً، وألهبتُ قصص غوايتهم أياماً ولياليَ قضيتها أُحارب الملل بالكتب والخيالات في عالم ما قبل الإنترنت ومواقع التواصل والقنوات المتعددة. اكتشفتُ وقتها فنون الإغراء الأنيق والمداعبات والمغازلات والتلميحات وشبه التصريحات وسحرتني كلمات مثل «باديناج» و«ليبرتيناج»، وقرأتُ كتب الرهبان الشبقين والأدباء المستثارين وحلّت الذروة المنطقية باكتشاف الماركيز دو ساد وفلسفته المبهرة في تجاوز الخطوط الحمراء والمحظورات كلها. هو كان خير معلم وأنا لدي الاستعداد الغريزي لتلقّي جميع ما قدمه للبشرية.
❂
ما زلت لا أستوعب تماماً رغبتي في الوجع رغم محاولاتي العديدة لتحليلها منطقياً ومن منظور نسوي وبيولوجي طبي أيضاً. قبل الشروع في كتابة هذا النص، بحثتُ قليلاً في المصادر الأكاديمية، فلم أجد سوى تحليلات طبية ونفسية ودراسات على عينات أشبه بالكليشيهات المستمدة من أفلام البورنو. عالم الأكاديميا يعشق تحويل الأفراد لمجموعات متشابهة تسهل التصنيف والقولبة الجاهزة. لستُ ضحية، ولم أتعرّض للعنف في صغري، ولستُ من ضمن النساء المطيعات المهذّبات الخجولات القابلات للتطويع وتنفيذ الأوامر. توقّفت عن طرح تلك الأسئلة، فلم أجد إجابات شافية. والتوجه النسوي الحالي المتأثر بالطهرانية الأنجلوساكسونية يذكّرني بتقزز قريباتي المتدينات من تلك الأفعال — أستغفر الله العظيم — التي يمارسها الرجال مع زوجاتهم ويستمتعون بها وحدهم (قرأت مرة لإحداهن تتّهم النساء المحبات للوضعية الفرنسية وللضرب على الأرداف أنهن يروّجن للعنف ضدّ النساء — لا تعليق)…عدا ذلك، لم أعد أرغب في تحليل كل شيء وإخضاعه لدراسات ونقد وتشريح.
ماذا لو استمتعت فقط؟
أوليس ما أنشده هو الذوبان في المتعة بشكل حسي تام حد نسيان كل شيء؟ ربما كان خدر الوجع المفضي للنشوة يشبه الخدر الذي يصاحب دوران الصوفيين ورقص النساء في الزار: تصاعد ثم انهيار واستسلام، أو ربما كان السبب مجردَ تفاعلات كيميائية في المخ مثل الشعور بالحب تماماً أو لربما كان التأثيرَ على النهايات العصبية ومعدّل ضخّ الدم أو الأوكسجين، أو إن الأمرَ ربما كلاهما معاً. لا أذكر بدقة ولا أريد أصلاً، لأن صورة انتصاب المشنوقين ستقفز بعدها إلى ذهني وتُفسد كل شيء.
ما أعرفه تماما هو أنني لست مازوخية بالمعنى المتعارف، ولا أتقبّل مجرد فكرة أن يكون لي «سيد»، كما يسمونهم في أوساط الـ «بي دي أس أم»، ولا أن أخضع لأي رجل مهما عشقته. كل ما أحبّ هو الوجع في مكامن المتعة، وأنا من قررت ذلك وعلى الطرف الآخر التنفيذ فقط. لا مجال ليفعل بي ما يشاء ولا أن يجرّب دون العودة إليّ.
وهذا ما فعلته لغاية الجزء الأول من هذه الليلة.
❂
الوضع كان تحت السيطرة التامة إلى أن ظهر ذلك الرجل، النسخة المعاصرة من فيكونت فالمون. يزنّ عقلي أن عليّ العودة للبيت والاكتفاء بهذا الحد من العبث والانحلال أو على الأقل إيجاد البار الملعون وترطيب حلقي المستجير والتفكير في الخطوة القادمة، أو ربما الانضمام إلى مجموعة ما أو حتى مشاهدة الآخرين. لكنني ورثت عن سلفاتي القطط فضولهنّ القاتل الذي يدفعني إلى الدخول في التجربة والوقوع في براثن الشرير بكامل إرادتي.
يجلب لي الشرير صينية كاملة مليئة بالمشروبات المختلفة و«يحضّرني» للجلسة على طريقته. يداه باردتان، إلا أنني لا أجرؤ على إخباره بذلك ليلتها، فعلت لاحقاً. هل سبق أن قلتُ إنني لا أحبّ القيود ولا منح السيطرة التامة على جسدي لأحد؟ يبدو أن ذلك كان وهماً داخل رأسي فقط.
لا أحبّ الوجع في المطلق. لا أتحمّل الصداع، وألم الأسنان يُذهب عقلي ويجعلني أتعامل مع أقراص المورفين على أنها حباتُ حلوى. كما أنني كدتُ أقبّل طبيب التخدير على شفتيه بعدما منحني الخلاص بإبرة الظهر وقت ولادتي الوحيدة. أنا فقط أحبّ ذلك الألم المفضي إلى اللذة والمرتبط بها. أيعقل أنني عشتُ تلك التجربة بنفسي في الواقع؟ طوال الوقت كنت أشاهد نفسي من خارج جسدي وكأنني أشاهد فيلماً أو مشهداً من روايات ساد. أخيراً، وجدت نفسي محلّ كل تلك النساء اللواتي حسدتهنّ على الوجود في مكان كهذا وتجارب شديدة الإثارة مثل تلك التي حظيت بها قبل قليل.
قبل قليل، كان جسدي غارقاً في عالم أثيري تحكمه الحواس فقط، غطاء عيني ساعدني على التخلص من عبء الرؤية التي تربطني بالواقع. لست سوى جسد مسجى فوق طاولة مبطنة بقطيفة وثيرة ناعمة، يستقبل موجات من الألم واللذة، موجات تخفت وترتفع، تغوص داخلي وأغرق فيها. لعلّ الشعور يشبه تجربة الخروج من الجسد أو حتى الموت. يتعانق إيروس وثاناتوس، تتجاور متعة الإحساس البحتة مع متعة انتهاك جميع المحظورات التي رافقت حياتي السابقة وخنقتها. يطهّرني الألم، لا تطهراً بمفهومه الديني من الخطيئة، بل تطهراً من الخضوع لمنظومة الأخلاق الخانقة التي لا تسمح لي بالخطيئة من الأصل. ها أنا أضعها في الحضيض وأدوس عليها وأنا عارية منتشية ونظرة الانتصار في عيني.
❂
الفجر في الخارج دافئ ولذيذ. أرتعشُ من تيار الهواء البارد الذي تثيره سرعة الدراجة النارية في الشوارع الباريسية الفارغة. نعود للحياة العادية تدريجياً ونخلعُ أقنعتنا وأدوارنا التي أجدنا تمثيلها. نتبادلُ أرقام هواتفنا عند باب البناية ويعودُ كل منا مثلما كان قبل الحفلة. لم أفقد فردة حذائي، ولا حتى براءتي، فقط غصت داخل أعماق نفسي وعرفت حدود جسدي وحدود رغباتي. سوف نتقابل كثيراً بعد تلك الليلة، سوف نمارس جنساً محموماً وآخر أكثر رتابة. سوف نترافق للسوق لشراء الجبن والطماطم وسوف أكتشف أنه ليس شريراً أبداً في النهار، بل يحضر لي الفطور في السرير كل مرة نكون معاً فيها.
لكنه في بعض الليالي، أو عندما أطلب منه ذلك، يصير مثل المذؤوبين، فتتلبّسه أرواح أسلافه المنحلين.
باحثة وكاتبة متخصصة في مجالات الجندر وحقوق النساء والأقليات والجنسانية في منطقة شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا. ناشطة نسوية تقدم جلسات تعليمية ومهتمة بتوثيق تاريخ النساء والفئات المهمشة وحياتهن. عضوة متطوعة في ويكي الجندر وتنشر على مواقع متعددة منها «نحو وعي نسوي»، و«شريكة ولكن»، و«الجمهورية»، و«كحل»، و«ماي كالي» و«رمان الثقافية».